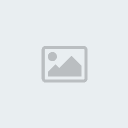[center][size=29]الأمــــــــــانة
- دخل أبو مسلم الخَوْلاَنِيُّ على معاوية بن أبي سفيان، فقال: السلام عليك أيها الأجير.
فقالوا: قُلِ السلام عليك أيها الأمير.
فقال: السلام عليك أيها الأجير.
فقالوا: قُلْ أيها الأمير.
فقال: السلام عليك أيها الأجير.
فقالوا: قُلِ الأمير.
فقال معاوية: دعوا أبا مسلم، فإنه أعلم بما يقول.
فقال: إنما أنت أجير استأجرك ربُّ هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هَنَأْتَ
جرباها، وداويتَ مرضاها، وحبست أُولاها على أُخراها، وفَّاك سيِّدُها
أجرها، وإن أنت لم تهنأ جرباها، ولم تداوِ مرضاها، ولم تحبس أولاها على
أخراها، عاقبك سيِّدُها[1].
- قام أعرابيٌّ إلى سليمان بن عبد الملك، فقال له: يا أمير المؤمنين، إني
مكلِّمك بكلامٍ فاحتَمْلُه إنْ كرهته، فإنَّ من ورائه ما تحبُّه إنْ
قَبلْتَه.
قال: هات يا أعرابي.
قال: فإني سأطلق لساني بما خَرِسَتْ عنه الألسن من عظتك بحق الله ، وحقِّ
إمامتك، إنه قد اكتنفك رجالٌ أساءوا الاختيار لأنفسهم فابتاعوا دنياك
بدينهم، ورضاك بسخط ربهم، خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك، فهم حربُ
الآخرة سِلْمُ الدنيا، فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه؛ فإنهم لم يألوا
الأمانة إلاَّ تضييعًا، والأُمَّة إلاَّ عسفًا، والقرى إلا خسفًا، وأنت
مسئول عمَّا اجترحوا، وليسوا مسئولين عمَّا اجترحتَ، فلا تُصْلح دنياهم
بفساد آخرتك، فأعظم الناس غبنًا يوم القيامة مَنْ باع آخرته بدنيا غيره.
فقال له سليمان: أمَّا أنت يا أعرابي فقد نصحت، وأرجو أن الله يُعِينُ على ما تقلَّدْنَا[2].
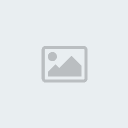
- عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن الزبير، قال: لما
وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه، فقال: يا بني، إنه لا
يُقْتَلُ اليومَ إلاَّ ظالم أو مظلوم، وإني لا أُرَانِي إلاَّ سأُقْتَلُ
اليوم مظلومًا، وإن من أكبر همِّي لَدَيْنِي، أفترى يُبْقِي دَيْنَنَا من
مالنا شيئًا؟ فقال: يا بني، بع ما لنا فاقضِ دَيْنِي. وأَوْصَى بالثُلُثِ
وثُلُثِهِ لبَنِيهِ -يعني بني عبد الله بن الزبير- يقول: ثلث الثلث فإن
فَضَلَ من مالنا فَضْلٌ بعد قضاء الدَّيْنِ فثُلُثُه لِوَلَدِكَ. قال هشام:
وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خُبَيْبٌ وَعَبَّادٌ، وله
يومئذ تسعة بنين وتسع بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بِدَيْنِه، ويقول:
يا بني، إنْ عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله ما دريتُ ما
أراد، حتى قلتُ: يا أبتِ، مَنْ مولاك؟ قال: الله.
قال: فوالله ما وقعت في كربة من دَيْنِهِ إلاَّ
قلتُ: يا مولى الزبير، اقض عنه دَيْنَهُ. فيقضيه، فَقُتِلَ الزبير t، ولم
يدع دينارًا ولا درهمًا إلاَّ أَرَضِينَ منها الغابة، وإحدى عَشْرَةَ دارًا
بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارًا بالكوفة، ودارًا بمصر، قال: إنما كان
دَيْنُهُ الذي عليه أنَّ الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إيَّاه، فيقول
الزبير: لا، ولكنه سَلَفٌ، فإني أخشى عليه الضَّيْعَةَ، وما وَلِيَ إمارة
قطُّ، ولا جباية خراج، ولا شيئًا إلاَّ أن يكون في غزوة مع النبي ، أو مع
أبي بكر، وعمر، وعثمان y، قال عبد الله بن الزبير: فحَسَبْتُ ما عليه من
الدَّيْنِ فوجدتُه ألفي ألفٍ ومائتي ألفٍ.
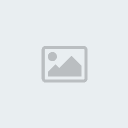
قال: فلَقِيَ حَكِيمُ بن حِزَام عبدَ الله بنَ
الزبير، فقال: يابن أخي، كم على أخي من الدَّيْنِ؟ فكتمه، فقال: مائة ألفٍ.
فقال حكيم: والله ما أُرَى أموالكم تَسَعُ لهذه. فقال له عبد الله:
أفرأيتك إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف؟ قال: ما أُرَاكُم تُطِيقُونَ هذا،
فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين
ومائة ألف، فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف، ثم قام، فقال: مَنْ كان
له على الزبير حقٌّ فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر، وكان له على
الزبير أربعمائة ألف، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتُها لكم. قال عبد الله:
لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخِّرون إن أخَّرتم. فقال عبد الله: لا.
قال: قال: فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله: لك من ها هنا إلى ها هنا. قال:
فباع منها، فقضى دينه فأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف، فقَدِمَ على
معاوية وعنده عمرو بن عثمان، والمنذر بن الزبير، وابن زمعة، فقال له
معاوية: كم قُوِّمَتِ الغابة؟ قال: كلُّ سهم مائةَ ألفٍ. قال: فكم بقي؟
قال: أربعة أسهم ونصف. قال المنذر بن الزبير: قد أخذتُ سهمًا بمائة ألف.
قال عمرو بن عثمان: قد أخذتُ سهمًا بمائة ألف. وقال ابن زمعة: قد أخذتُ
سهمًا بمائة ألف. فقال معاوية: كم بقي؟ فقال: سهم ونصف. قال: أخذتُه بخمسين
ومائة ألف.
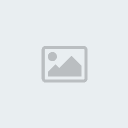
قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة
ألف، فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه، قال بنو الزبير: اقسم بيننا
ميراثنا. قال: لا والله، لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنينَ ألاَ
مَنْ كان له على الزبير دَيْنٌ فليأتنا فلنقضه. قال: فجعل كل سنة ينادي
بالموسم، فلمَّا مضى أربع سنين قسم بينهم، قال: فكان للزبير أربع نسوة،
وَرَفَعَ الثُّلُثَ، فأصاب كلَّ امرأة ألف ألف ومائتا ألف، فجميع ماله
خمسون ألف ألف ومائتا ألف[3].
- قال أبو حنيفة: كنتُ مجتازًا فأشارتْ إليَّ امرأة
إلى شيء مطروح في الطريق، فتوهَّمْتُ أنها خرساء وأنَّ الشيء لها، فلمَّا
رفعتُهُ إليها، قالت: احفظه، حتى تُسَلِّمَهُ لصاحبه[4].
- لما ولي الحجاج بن يوسف الحرمين، بعد قتل عبد الله
بن الزبير استحضر إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله، وقرَّبه في المنزلة فلم
يزل على حاله عنده، حتى خرج إلى عبد الملك زائرًا له فخرج معه فعادله لا
يترك في برِّه وإجلاله وتعظيمه شيئًا، فلما حضر باب عبد الملك حضر به معه،
فدخل على عبد الملك فلم يبدأ بشيء بعد السلام، إلاَّ أن قال: قدمت عليك يا
أمير المؤمنين برجل الحجاز، لم أدع له -والله- فيها نظيرًا في كمال المروءة
والأدب والديانة، ومن الستر وحُسْن المذهب والطاعة والنصيحة، مع القرابة
ووجوب الحق: إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله، وقد أحضرته بابك؛ لتسهل عليه
إذنك، وتلقاه ببشرك، وتفعل ما تفعل بمثله، ممن كانت مذاهبه مثل مذاهبه.
فقال عبد الملك: ذكرتنا حقًّا واجبًا ورَحِمًا
قريبًا، يا غلام، ائذن لإبراهيم بن طلحة. فلما دخل عليه قرَّبه حتى أجلسه
على فرشه، ثم قال له: يابن طلحة، إنَّ أبا محمد أذكرنا ما لم نزل نعرفك به
من الفضل والأدب وحسن المذهب، مع قرابة الرحم ووجوب الحقِّ، فلا تدعنَّ
حاجة في خاصِّ أمرك ولا عامَّته إلاَّ ذكرتها. قال: يا أمير المؤمنين، إنَّ
أَوْلَى الأمور أن تُفْتَتَحَ بها حوائج، وتُرْجَى بها الزُّلَف ما كان
لله رضًا، ولحقِّ نبيه أداء، ولك فيه ولجماعة المسلمين نصيحة، وإن عندي
نصيحة لا أجد بُدًّا من ذكرها، ولا يكون البوح بها إلاَّ وأنا خالٍ، فأخلني
تَرِدْ عليك نصيحتي. قال: دون أبي محمد؟ قال: نعم. قال: قُمْ يا حجاج.
فلمَّا جاوز الستر قال: قُلْ يابن طلحة نصيحتك.
قال: اللهَ، أمير المؤمنين، أمير المؤمنين. قال:
الله. قال: إنك عمدت إلى الحجاج مع تغطرسه وتعترسه، وتعجرفه وبُعْدِهِ عن
الحقِّ وركونه إلى الباطل، فولَّيْتَهُ الحرمين، وفيهما مَنْ فيهما، وبهما
من بهما من المهاجرين والأنصار والموالي المنتسبة الأخيار، أصحاب رسول الله
، وأبناء الصحابة، يسومهم الخسف، ويقودهم بالعسف، ويحكم فيهم بغير السنة،
ويطؤهم بطغام أهل الشام، ورعاع لا رويَّة لهم في إقامة حقٍّ، ولا إزاحة
باطل، ثم ظننت أن ذلك فيما بينك وبين الله يُنْجِيكَ، وفيما بينك وبين رسول
الله يخلصك إذا جَاثَاك للخصومة في أُمَّتِهِ، أَمَا والله لا تنجو إلاَّ
بحُجَّة تقيمنَّ لك النجاة، فأَبْقِ على نفسك أو دَعْ، فقد قال رسول الله : “كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ”.
فاستوى عبد الملك جالسًا، وكان متَّكِئًا، فقال:
كذبت -لعمرو الله- ومِنْتَ ولؤمت فيما جئت به، قد ظنَّ بك الحجاج ما لم يجد
فيك، وربما ظنَّ الخير بغير أهله، قُمْ فأنت الكاذب المائن الحاسد. قال:
فقمت، والله ما أُبْصِرُ طريقًا، فلمَّا خلفت الستر لحقني لاحق من
قِبَلِهِ، فقال للحاجب: احبس هذا، أَدْخِل أبا محمد للحجاج. فلبثتُ مليًّا
لا أشكُّ أنهما في أمري، ثم خرج الآذن، فقال: قُمْ يابن طلحة، فادخل. فلما
كشف لي الستر لقيني الحجاج وأنا داخل وهو خارج، فاعتنقني وقَبَّل ما بين
عيني، ثم قال: إذا جزى الله المتحابِّين بفضل تواصُلِهم فجازاك الله أفضل
ما جزى به أخًا، فوالله لئن سلمتُ لك لأرفعنَّ ناظرك، ولأُعْلِيَنَّ
كَعْبَكَ، ولأتبعنَّ الرجال غبار قدمك. قال: فقلت: يهزأ بي.
فلما وصلتُ إلى عبد الملك أدناني حتى أجلسني مجلسي
الأول، ثم قال: يابن طلحة، لعلَّ أحدًا من الناس شاركك في نصيحتك؟ قال:
قلت: لا والله، ولا أعلم أحدًا كان أظهر عندي معروفًا ولا أوضح يدًا من
الحجاج، ولو كنت محابيًا أحدًا بديني لكان هو، ولكن آثرتُ الله ورسوله
والمسلمين. فقال: قد علمتُ أنك آثرتَ الله ، ولو أردتَ الدنيا لكان لك
بالحجاج أملٌ، وقد أزلتُ الحجاج عن الحرمين لِمَا كرهتَ من ولايته عليهما،
وأعلمتُه أنك استنزلتني له عنهما استصغارًا لهما، وولَّيْتُه العراقين لما
هنا من الأمور التي لا يَرْحَضُهَا إلاَّ مثلُه، وأعلمتُه أنَّك استدعيتني
إلى التولية له عليهما استزادة له؛ ليلزمه من ذمامك ما يُؤَدِّي به عنِّي
إليك أجر نصيحتك، فاخرج معه فإنك غير ذامٍّ صحبته مع تقريظه إيَّاك ويدك
عنده. قال: فخرجت على هذه الجملة[5].
-------------------
[1] ابن تيمية: السياسة الشرعية، باب أداء الأمانات.
[2] أحمد بن مروان الدينوري: المجالسة وجواهر العلم ص134.
[3] البخاري: كتاب الخمس، باب بركة الغازي في ماله حيًّا وميتًا مع النبي (2961).
[4] ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص425، وابن الجوزي: أخبار الظراف والمتماجنين ص152.
[5] المعافى بن زكريا: الجليس الصالح والأنيس الناصح ص14.